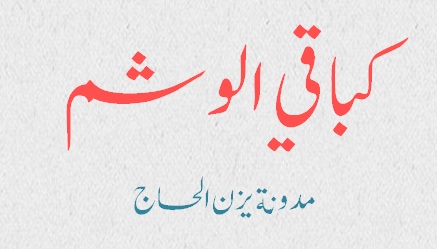«لن»: لعنات
لزمن قادم
في البدء كان
الخوف، وفي الختام كان التمرّد، وبينهما عاش أنسي الحاج. ليس غريباً أن يبقى أنسي
متفرّداً وموشوماً بلعنة مجايليه، ومرجوماً بحجارة الباحثين عن «الاستقرار». لم
يكن لهذا النبيّ حواريّون أو أتباع؛ ولعل هذه السمة هي ما ميّز أنسي عن «شعراء
مجلة شعر»، وما جعله (إلى اليوم) شاعرها «الملعون».
ما من مبالغة في القول إنّ شعر أنسي لم يُدرس دراسة نقدية
حقيقيّة إلى اليوم. بقي شعره دوماً على هامش «الحركة» النقدية العربية المحكومة
(في معظمها) بفصل تام بين تطرّفَيْن: مديح مفرط أو ذم هدّام، أما ما يشذ عن هذين
التصنيفين، فلا يحاول التأسيس لبناء نقديّ مستقل أو حتى «منزلة بين المنزلتين»، بل
يستند إلى «ثقافة عربيّة» مديدة شغوفة بالمقارنات. وقد كان معظم نقّاد شعر أنسي
الحاج من أنصار الاتجاه الأخير، حين عجزوا عن التقاط فرادة هذا الشاعر فألحقوه
بـ«مدارس» أو «تيارات» مكرّسة، كأن يقارنوه بالمدرسة الرؤيويّة الأدونيسيّة أو
«القصيدة اليومية» الماغوطية، وإنْ كان ذلك لإظهار بأنه «هجين» بين هاتين
المدرستين. أو عمدوا إلى القول إنه سليل المدرسة الفرنسيّة لقصيدة النثر، دون
الأخذ في الاعتبار التيارات المتباينة والمتمايزة في القصيدة الفرنسيّة وشعرائها.
وربما يعود هذا التردد النقدي إزاء أنسي إلى أيام تأسيس مجلة
«شعر» (1957)، إذ كان من بين الأسماء التي واكبت تقلّبات المجلة الشعرية الأشهر
والأبرز في القرن العشرين، ابتداءً بتأسيسها الجريء، وانتهاءً بإغلاقها المتكرر
عدة مرات، مروراً بالمعارك والجدالات التي شنّها كثيرون ضد تلك المجلة، ومن بينهم
«أبناء» لها، بدأوا مسيرة «ردّتهم» بإعلان التنصّل من تلك «الخيمة» التي آوت جميع
البذور الشعرية التي ستُزهر بتنوعات شتى في السنوات اللاحقة. وتجدر الإشارة هنا
إلى أن السنوات الثلاث التأسيسيّة للمجلة (1957ــ1960) ما تزال حقلاً بكراً لم
يقاربه النقد الجاد إلا في استثناءات نادرة. كانت تلك السنوات هي الحامل الأبرز
لمعظم الدواوين الأولى للشعراء الذين سيصبحون الشعراء الأبرز في السبعينيات، وكانت
أعداد «شعر» ومنشوراتها هي البوصلة الفعليّة في الكشف عن «الشمال الشعريّ» الذي
ستتجه إليه القصيدة العربية في مسيرتها المضطربة.
خلال تلك السنوات، وصولاً إلى المحاولة المخفقة لإحياء مجلة
«شعر» في الثمانينيات، كان أنسي هو الشاعر الوحيد (إذا استثنينا المؤسس يوسف
الخال) الذي شهد «تقلبات» المجلة، ومضى يكتب وينظّر لقصيدة النثر. ويمكننا القول
إنّ باكورته الشعرية «لن» (1960)، بقصائدها ومقدّمتها النظريّة، هي المعبّر الأفضل
عن الأفكار الفعليّة لمجلة «شعر»، قبل أن تعاني تلك الأفكار، لاحقاً، من تعديلات
وانحرافات ترافقت مع ابتعاد شعرائها عن تلك «الخيمة»، ليؤسسوا خيمهم الخاصة التي
بقيت مرتبطة عضوياً بالمجلة الأم وأفكارها، وإنْ اختلفت سبل أبنائها.
في ديوان «لن»، سنجد روح قصيدة النثر وعمودها الفقري النظريّ.
أنسي كتب مقدّمته الشهيرة تلك وهو مدرك أنّه يؤسّس لعالم شعري جديد. وللمفارقة،
يمكننا اعتبار أن تلك المقدّمة عاشت أكثر من القصائد المرافقة لها، إذ ما زالت مقدّمة
«لن» هي البيان الأشد توازناً ووضوحاً لقصيدة النثر، حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن
على كتابتها. بينما لن تجد معظم قصائد ذلك الديوان مكاناً متقدماً لها اليوم إذا
وضعناها تحت عدسة نقد صارم. كانت تلك القصائد ابنة لزمن كتابتها، بينما كانت المقدمة
النظرية ابنة لزمن قادم. وقد كان أنسي مدركاً لهذه المسألة، برغم نفوره من التنظير
الشعري، لذا كانت دواوينه اللاحقة، بخاصة «الوليمة»، مختبراً شعرياً لتلك الأفكار
النظرية، مبتعدة عن الصرخة الأولى في «لن»، من دون أن تتخلى – في الوقت ذاته – عن «الثوابت» الأبرز في شعر
أنسي؛ أي، التمرد والخوف و«خيمياء» اللغة (بمعنى إخضاعها الدائم لثورات متلاحقة)،
والروحانية الشفيفة.
ومجدداً، ما من مفر من تكرار القضية الجدليّة الدائمة بين
الإبداع والنقد، ولا أعتقد أنّ ثمة مبالغة في القول إنّ شعر أنسي متقدّم على نقّاده
بمراحل عظيمة. كان شعر أنسي الحاج (ونثره بصورة أوضح) أعمق بأشواط من الكلام
المعتاد في المقالات والدراسات «شبه النقدية» التي تحاول مواكبة مسيرة الشعر
العربيّ. كان أنسي يُذهل قرّاءه ونقّاده دوماً بقفزات يتزايد عمقها مع كل ديوان
جديد. حتى المرأة، التي تعدّ «الثابت» الأهم في شعره، تظهر بصور متعددة ومتناقضة
في كل قصيدة جديدة؛ هي القديسة أحياناً، العاهرة أحياناً، الكون بأسره تارةً،
والتفصيل المنمنم تارة أخرى، والإيروتيكيّة دوماً. ولا يمكن فهم شعر أنسي دون
المحاولة المثابرة لفهم صورة المرأة لديه. ولعل تغيّر هذه الصورة وتباين أصدائها
لديه كانا السبب الأكبر في تهمة «الغموض» التي أُلصقت بأنسي، دون أن ننسى «المختبر
اللغويّ» الدائم لديه في كل قصيدة؛ «فالشاعر لا ينام على لغة»، كما عبّر في
مقدّمته الشهيرة.
إن فرادة أنسي الحاج (شعراً ونثراً) تكمن في كونه يعيش دوماً
على التخوم، ما جعله عصيّاً على التصنيف. إنه يتأرجح دوماً بين الهوامش: هوامش
الروحانية، التمرد، المسيحية، السوريالية، التصوف، الإيروتيكية، واللغة. وتلك هي
الصفة الأهم للنثر، كحالة كتابيّة وحياتية في آن واحد، ولذلك أوغل أنسي الحاج في
النثر كداء وترياق في الوقت ذاته في «زمن السرطان» الذي لا فرار منه، ولا حياة
فيه، إلا للمتمردين والخائفين والمجانين والملعونين.
لا مكان للرضا، لا مكان
لليقين
هل كان علينا انتظار أكثر من نصف
قرن لنكتب عن أنسي؟ أسماء كثيرة عبرت أرض الشعر، وهذا «العارف» يتأبّط سرابه بصمت
كدأبه. لم تغيّره الحرب، أو الابتعاد عن الأضواء الحارقة، أو المعارك «الظلاميّة»
التي تسعى إلى نسف الأرض بما فيها، بكلّ عابريها، إلا بما يتلاءم مع حدود ما
تلقّنوه من معلّميهم الأكثر جهلاً. بقي الصامت الدائم، الذي لا يفضّل الصراخ،
والذي يأبى إلا أن يغيّر الحياة والشعر والنثر بالهمس. الهمس، وحده، هو الثابت،
وكلّ ما عداه عابرٌ كالأسماء الرنّانة.
هل كان أنسي الحاج (1937) يعرف
بأن بيانه الشهير في ديوانه الأول «لن» (1960)، لا يزال إلى اليوم يعكّر صفوّ
كارهي التغيير؟ هل كان يعرف بأنّ «الظلاميّين» من أهل السلطة، مثقفين وسياسيّين
على حد سواء، سيتآمرون خفية لإعدام أعماله الكاملة في القاهرة قبل عدة سنوات؟ لا
نعلم حقاً درجة تعويله على «الكلمة» كسلاح بيد من تبقّى من «الروّاد» المخلصين
الأوائل للتغيير، ولكننا نجزم بأنّ هذا اللامبالي بالشهرة أدرك بأنّ أعداء الكلمة
هم أكثر من يساهمون في تقويتها، وبأنّ أعداء «الربيع» (الذين امتطوا موجته فيما
بعد) هم آخر من يحق لهم الكلام عن التغيير.
منذ تأسيس مجلة «شعر»، بدا بأنّ
صاحب «لن» يؤسس لشيء أكبر من مجرد الاكتفاء بعضويّة هيئة تحرير في المجلة الشعريّة
الأكثر شهرة، وبأن هذا الشاعر «الأنقى»، سيمضي لتأسيس مشروع شعريّ (ونثريّ لاحقاً)
يشبهه في الهمس الجارح. وبرغم أن شعر أنسي الحاج يستحق الكثير من الكتابة والتقييم
النقديّ، إلا أنّنا نعتقد بأنّ كتابه النثريّ «خواتم» بجزأيه (1991، 1997) يستحق
ضوءاً أكبر، بخاصة وأنّ «بوصلة الكتابة الجديدة» اليوم تومئ إلى أنّ خيارات أنسي
الكتابيّة كانت هي الأكثر صواباً بين مجايليه، وبأنّ النثر هو غد القصيدة والحياة
بأسرها، وبأنّ المعارك الجانبيّة بين الأجيال الشعرية لن تثمر إلا العبث، وبأنّ «الشذرات»
هي اللغة الجديدة للجيل الذي لم يعوّل عليه أحد، جيل فيسبوك والانتفاضات، الكاره
للغة الخطابات الرنانة التي كانت ولا تزال أهم أسباب خيباتنا المتلاحقة.
يبدو كتاب «خواتم»، بتاريخ نشره الذي
تزامن مع انهيار الاتحاد السوفييتي، ومحتواه غير الاعتياديّ آنذاك، أشبه ببيان آخر
لـ «سراب العارف» (وهو الاسم المستعار الذي لجأ إليه أنسي في سنوات الحرب) الذي
اعتزل الحياة العامة زمن الحرب الأهلية، بل يبدو أقرب إلى «مانفستو» ثوريّ جديد
لجيل مابعد الحرب الباردة، وانهيار «الكبار» في السياسة والثقافة. الجيل الذي
اعتاد هزائم آبائه، ومضى في طريقه الخاص ليرسم ملامح مرحلة ستأتي بعد عقدين. في «خواتم»،
لن يجد القارئ قولاً فصلاً، بل سيلاحظ اتّساع موشور الحياة بوجوهها وألوانها
المتعددة. سيجد أسئلة طازجة عجز عنها الشعر بكلّ مدارسه، أسئلة التحرر، الحداثة،
الإيمان، الكفر، والتمرّد. كما سيجد إجابات عابرة لمسائل كانت تؤرّقه منذ سنوات. «خواتم»،
الذي اعتبره البعض بأنه استراحة المحارب لصاحب «الرسولة بشعرها الطويل حتى
الينابيع»، أثبت بأنّ هذه اللغة المتشكّكة بكلّ شيء هي أساس الكتابة القادمة. إذ
تفجّرت خلال السنوات الثلاث الماضية براكين من هذه «الكتابة المغايرة» التي أوشكت
أن تصبح هي الجنس الأدبي الأوحد، حيث بدأ «الجيل الضائع» من الكتّاب الجدد بالبوح
في زمن الانتفاضات والحروب، ولا سلاح لهم سوى هذه الشذرات، وذلك الهمس. كان الكتاب
(لحظة نشره، والآن أيضاً) بمثابة ردّ غير مباشر على معظم منتقدي «تقلّبات» أنسي
الحاج السياسية والفكرية. «مَنْ يصنّفك يقتلك»، يقول أنسي، وتقول سطور «خواتم»
العصيّة على التصنيف. سطور تحمل النثر، الشعر، التأمل، الفلسفة، بل وحتى الخربشات
العجولة. وبذلك، يبدو «خواتم» أقرب إلى جيل الألفيّة الثالثة، أكثر من تلاقيه مع
مجلة «شعر» ومريديها، أو حتى مع «التيار النثريّ الجديد» الذي اتجه إليه الشعراء
الآخرون كمحمود درويش في «في حضرة الغياب».
هاجس التحرر هو أكثر ما يمكن
التقاطه في نصوص «خواتم». الهاجس المتّسم بالقلق، الشك، والتردّد. لا مكان للتعصّب
في «خواتم» أنسي، لا مكان لليقين، لا مكان للرضا، ولذا لا مكان لـ «امتلاك الحقيقة».
وهذا الادعاء بامتلاك الحقيقة، كل الحقيقة، كان أهم سمات «ديناصورات» السياسة
والثقافة، «الثورجيّين» الجدد، الذين عاودوا الهجوم على أنسي الحاج في العامين
الأخيرين. وبرغم أنّ العين المدقّقة يمكنها التقاط أصداء أنسي في كتاباتهم (التي
وصلت في حالات متفرقة إلى «تلاص» تام)، إلا أنّهم تناسوا بأنّ اللغة عصيّة على
التقليد، وبأنّ بذور التمرّد لا تنتقل عن طريق الهواء، وبأن الاكتفاء بالتنظير
للحرية لا يعني ممارستها.
تناسى هؤلاء المنتقدون بأنّ من
كتب يوماً «الرجولة لهذا النظام [نظام القوة العسكريّة والبوليسيّة] هي نباح قائد
الجنود بأوامره وامتثال الجنود للنباح. الرجولة هي الرأس الحليق من خارج ومن داخل.
هي الثكنة. هي اختصار العالم إلى حدود ما يجهله المتعصّب الأحمق، وما زاد كان
للحذف والقتل»، لا يمكن أن يكون معادياً للتحرر، أو مناصراً لدكتاتورية ما، دينيّة
كانت أم «علمانيّة». وبذا، كان تعريف «الحرية» بحد ذاته، هو الفارق الأهم بين
الطرفين المتمايزين والمتناقضين.
هذا التحرر هو الشاغل الأساسي
لصاحب «خواتم» الذي يتابع كتابة الجزء الثالث في «الأخبار». ومن يتابع «خواتم-3»،
سيلاحظ بأن أنسي مشغول بإعادة تعريف ما اعتُبر لسنوات بمثابة أمر واقع؛ يبدأ بما
ظنّ الآخرون بأنه القول الفاصل، والنهاية، و«الحقيقة». يبدأ بانتقاد بيانه القديم
في مجموعته «لن»، ولغته القديمة، وشعره القديم، محاولاً إيجاد فسحة لـ «الجديد»،
لغة وأفقاً. ليس الشكل هو وحده ما يجدّد أفق الكتابة، وليس العمر وحده ما يصنّف
الأجيال، بل هو طزاجة الأفكار وتمردها. «إلى أي مدى أكون «حراً» ما دمت مراعياً،
وأنا أكتب، جانب القراء؟» يتساءل أنسي عام 1997، ليبدأ تطبيق هذه «الثورة» في
الكتابة في «خواتمه» الجديدة. ليس القراء كُلاً واحداً موحّد الصفات والأمزجة؛
التماثل سيعيدنا إلى الثكنة وعالمها المتشابه والمعادي بالضرورة للفن، وكلّ ما هو «بدعة».
هذا القارئ المتفرّد هو الهدف الذي يسعى إليه أنسي، وتسعى إليه شذرات «خواتم-3».
«الحرب لا تُبكيني. أغنية صغيرة
قد تبكيني، أو كلمة لأنسي الحاج»، يقول الماغوط. هذا البكاء «الآخر» هو الأداة
التي ستغيّر النفوس التي اعتادت تصنيف الضحايا، وتصنيف الحزن، وتصنيف الحياة. وكما
هي الأغاني «مشاع»، يحاول أنسي الحاج في «خواتمه» إعادة «المشاعيّة» إلى الكتابة
والتحرر، إلى أجيال اعتادت ذلك الانفصال الحاد بين «نخبة» عارفة ومتلقّين جاهلين،
بين الحاكم والمحكوم، بين من يبيع الحرية ومن يشتري ما يناسبه منها. «خواتم» أنسي
الحاج هي هديّة قرنٍ كامل لقرن آخر، بكلّ لحظات جموحه، تحرّره، قلقه، شكّه،
ومحبّته.
مثل رشّة عطر
عزيزي أنسي،
ها قد مرّ عامٌ على أولى كتاباتي
عنك. لم أشعر بمرور كل هذه الأيام، هل شعرت أنت بذلك؟ لا أعلم إن كان الزمن لديك
ينقضي بالسرعة ذاتها كما هنا. بالأحرى، لا أعلم ولا أكترث. كلّ ما يهمّ
"الأحياء" هو مرور زمنهم الخاص، لا زمن من رحلوا حتى لو كانوا مقرّبين.
وأنت لست مقرّباً إلى هذا الحدّ. لست كاتبي المفضّل لو أردت الصراحة. أنت أحدهم
بلا شك، ولكنّك لست المفضّل.
ربما لا يصلح المقطع السابق
كافتتاحيّة تليق بذكراك الأولى. ولكن هذا ما خطر لي فور أن كُلّفت بكتابة رسالة
إليك. لا أنكر بأنّني كنت أريد التهرّب من هذا "الواجب"، لكنّني غيّرت
رأيي وقررت أن أكتب ما أشعر به بكل صراحة. في الحقيقة، لو أردت صراحةً أكبر، كنت
أريد أن أفتتح الرسالة بالقول "لمَ متّ منذ عام لتضعني الآن في هذا الموقف
السخيف"، إذ وجدتُ بأنّ السخافة تليق أحياناً بهذا العام الذي انقضى، فقرّرت
المضيّ في الكتابة بضمير مرتاح، بخاصة وأنّك لن تتمكّن من الردّ عليّ. أو هذا ما
أعرفه، على الأقل، عن عالمك الآن. رسائل لا تصلح إلا للتجاهل وعدم إمكانيّة الرد.
شعور رائع برأيي. ولذا، سنُبقي الأمور على ما هي عليه. لنتحدّث عن البداية، وعن
الافتتاحيّات.
عرفتك منذ عشر سنوات. لم يكن ابن
التاسعة عشرة حينذاك يعرف عنك أكثر من عنوانٍ مغرٍ لمجموعتك الأولى
"لن"، وتاريخ طويل مع جريدة "النهار". لم أقرأ "لن"
في البداية، ولم أتشجع لقراءتك إذ ارتبط اسمك مع جريدة أكرهها، إلى أن تعثّرتُ بـ
"الوليمة". كان "الوليمة" أول ديوان أقرؤه لك. قرأته بموقف كاره
مسبق للأسباب السابقة، عدا عن عنوانه "غير الشعريّ"، إضافة إلى تشابه
غلافه مع غلاف ديوان لمحمود درويش، وهو كان شاعري المفضّل آنذاك. كان الغلافان
متماثلين تقريباً: "الوليمة" و"لماذا تركت الحصان وحيداً".
أدركت لاحقاً بأنّ التماثل لم يكن يقتصر على الغلاف، إذ كان كلا الكتابين انطلاقة
جديدة لكلّ منكما، ولذا عشقت الكتابين بالدرجة ذاتها، بل وعشقت
"الوليمة" أكثر لأنه فتح أمامي بوابة جديدة لقراءة شعر
"جديد". لا أعني الشكل هنا، ولا المضمون حتى، بل سحر اللغة، وبراعة
المخيّلة، وإغواء الشعر حين يدور حول المرأة بطريقة أنسي الخاصة، حيث تكون فيه
المرأة ولا تكون، وحيث يكون الشعر الحقيقيّ في آخر مكان يمكن أن تتوقّعه، وآخر
عنوان قد يخطر في ذهنك. ثم كان "خواتم" الذي استند إليه مقالي عنك قبل
عام: كان حواراً من طرف واحد، إذ كنت قد رحلت، وكان الحوار مع "خواتمك".
في هذا الحد الفاصل بين عالمين كان لقاؤنا الأول، والآن رسالتنا الأولى. بين عالمٍ
زائلٍ للأحياء، وعالمٍ قصيٍّ للراحلين.
أعدت قراءتك عدة مرات خلال هذه
السنوات العشر لأثبت لنفسي مدى سذاجتي وحماقة مواقفي المسبقة. كنتُ في اندفاعة
الشباب الجامحة آنذاك حيث لا حيّز لدرجات الألوان، ولا مكان لجزيرة في المحيط
المتلاطم. أدركت لاحقاً (في السنة الأخيرة خصوصاً) بأنّ تلك السذاجة والحماقة تسم
مجتمعنا بأسره. أتحدث عن المجتمعين السوريّ واللبنانيّ على الأقل. كارهوك بالأمس
أحبّوك اليوم لأنك أصبحت في "الأخبار"، وكانوا سيكرهونك لو انتقلت إلى
تلك الصحيفة قطريّة التمويل. ومحبوك بالأمس كرهوك اليوم وكانوا سيحبّونك غداً ربما
لولا أنك فاجأت الجميع فرحلت، لتبقى ذلك "الأنقى" من بين جميع فرسان
مجلة "شعر"، ولتبقى بعيداً عن كلّ من حاول تصنيفك. "من يصنّفك
يقتلك"، هذا ما كنتَ تؤكّد عليه دوماً، لذا لم يستطيعوا قتلك إلى اليوم.
سيتذكّر معظم قرائك أو حتّى حفظة
العناوين من "مثقفينا" كتبك الشهيرة، وسيغفلون عن "الوليمة"،
ولذا سأُفشي سرّك لمن يريد قراءتك فعلاً. "الوليمة" هي أنسي، كما
"النهايات" هي عبد الرحمن منيف، كما "الاعترافات" هي ربيع
جابر، كما "النحنحات" هي إبراهيم صموئيل، كما "يا طول عذابي"
هي أم كلثوم، وكما "اسقنيها" هي أسمهان. تلك الأعمال شبه المنسيّة هي ما
سيتبقّى بعد امتلاء الذاكرة بالعناوين المكرّسة. تلك الهمسات هي ما سيتبقّى بعد
تلاشي الصخب. ولذا ستبقى أنت، حتى بعد مرور سنوات وسنوات على الرحيل، كما العطر،
دون أن يكون ثمّة معنى للعلب التي وضعوك فيها، بصرف النظر عن بهرجتها.
نُشرت الأقسام الثلاثة في جريدة «الأخبار». القسمان الأوّلان في
اليوم الذي أعقب وفاة الشاعر (19 شباط/فبراير 2014)، أما القسم الثالث فنُشر بعد
عام على رحيله (18 شباط 2015).