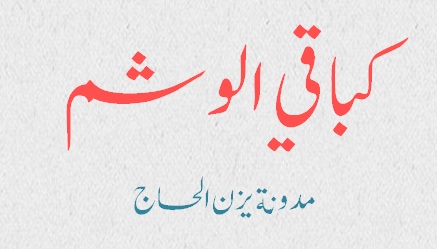ربما لا
يمكن إنكار أنّ ظاهرة محمد شحرور كانت إحدى أهم الزلازل التي أسهمت في تحريك مياه
المشاريع الفكريّة الدينيّة خلال العقدين الآخرين. ولعل السبب الأكبر في بروز هذا
الزلزال هو أنّ شحرور لم يأت من البوابة الفقهيّة التقليديّة، أي من الأكاديميا
الدينيّة أو حتى المنابر الفقهيّة التقليديّة. كانت الرياضيات هي النافذة التي أطل
منها شحرور لتقديم تأويل جديد كلياً لأكبر قضية فقهية إشكاليّة، هي علم المواريث؛
لينتقل منها إلى تقديم مشروع إسلامي شديد البعد عن التأويلات الفقهية التراثية
والتقليدية. كان هذا المشروع عصياً على التصنيف: إنّه مشروع «هدّام» بحسب منتقديه،
ومشروع «متنوّر» بحسب مناصريه، ولكنه، دون أدنى شك، أحد أهم المشاريع الإسلاميّة
الإشكالية المعاصرة.
ليس ثمة
طرح جديد في أحدث كتب محمد شحرور «الإسلام: الأصل والصورة» (طوى للثقافة والنشر)،
بل إن هذا الكتاب يبدو أشبه بتلخيص لأفكار شحرور السابقة. الكتاب مجموعة محاضرات
ومقالات مستعادة تتناول مواضيع متشعّبة من فلسفة قصة الخلق والروح، إلى التمييز
بين الإسلام والإيمان والرسالات، وانتهاء بالقسم المتعلق بمسألة المرأة في الإسلام
في قضيتين مهمتين هما مفهوم «القوامة» و«التعددية الزوجية». تندرج جميع فصول
الكتاب تحت عنوان عريض هو الإصلاح الديني، الذي يمكن لنا أن نلخص عبره أفكار شحرور
المستعادة.
يؤكد
الكاتب بأنّ ما نحتاجه اليوم هو الإصلاح الفكري والثقافي، ومن ضمنه الإصلاح الديني،
وهو أحق بالأولوية من الإصلاح السياسي، وبأن غياب الوعي بمفاهيم الحرية والعدالة
(وهو يؤكد بأن الإسلام خلا من أي تأكيد على مفهوم الحرية، إلا بما يخص مفهوم «الرق»
الأقرب لمعنى العدالة لا الحرية) ووضع الدين في خدمة السياسة هو السبب الأكبر في
ظهور الحركات المتطرّفة. كما يؤكد على أنّ أول ما تحتاج إليه الحركات الإسلامية هو
إعادة النظر في مرجعياتها لأن الأحكام تتغير بتغيّر الأزمان، وبالتالي ينبغي
التأسيس لـ «قواعد فقهية معاصرة».
ولكن، بعيداً
عن اليافطة المغرية لهذا العنوان (المغرية للكتّاب «العلمانيّين» المناصرين لأفكار
شحرور بشكل خاص)، لا يبدو بأنّ هذا المشروع يبتعد كثيراً عن جوهر الفكر الديني. ليس
الدين هو مصدر الإشكاليّة، بل هو التطبيق والتأويل الخاطئان له. هذه هي العبارة
التي يمكننا فيها إيجاز جميع الأفكار الدينيّة «الإصلاحيّة»، بما فيها مشروع محمد
شحرور. بالطبع، لا يمكن لنا أن ننكر جرأة هذه الأفكار أو عقلانيتها (بخاصة ما
يتعلق بقضيّة المرأة في الإسلام) ولكن يبدو بأنّ الفارق الوحيد الذي يميّزها عن
الأفكار الأخرى هو أنّ شحرور يستند إلى خلفيّته المعرفية غير الدينية كمصدر قوة،
تاركاً معظم منتقديه في الطرف الآخر من المعادلة بوصفهم «رجال دين»، دون أن يعلم
بأنّ هذا التصنيف بذاته هو المصدر الأهم لهشاشة جميع هذه المشاريع الدينيّة؛ إذ إن
اعتماد الكاتب على التقسيم الحاد بين «رجال الكهنوت» (التقليديّين التراثيين
بالضرورة)، و«رجال العلم» (المتنوّرين والعقلانيّين) ليس سوى وسيلة لتقوية أطروحته
الأساسية القائمة على ثنائية الأصل والصورة. ولكن، فعلياً، فإنّ أفكار شحرور
بذاتها هي «صورة» أخرى لما يظنّ هو بأنه «الأصل». القضية عند شحرور، وعند جميع «الإسلاميين
الإصلاحيين» هي أنّ شكلاً جديداً للإسلام سيؤدي بالضرورة إلى إدخاله ضمن آليات
العصر الحالي، وبأنّ هذا الشكل هو إصلاحي لا ثوريّ؛ أي إنّ مقدار هذا «الإصلاح» لن
يتعدّى التفاصيل أو الأفكار الثانوية للفقه الإسلامي وتشريعاته، ولا يجوز التشكيك
بجوهر هذا الفقه أو أفكاره الأساسية.
ليس ثمة
فارق بين طروحات من يصفهم شحرور نفسه بكونهم «تراثيين» وبين طروحاته بذاتها، بل هي
مجرد صياغة ورتوش مختلفة للفكرة نفسها. إنّ الدين لديهم ليس مجرد مكوّن من مكوّنات
الهويّة والحياة لدى سكّان هذه المنطقة التي سكنها الإسلام، بل هو «المكوّن
الأساسيّ للثقافة والمحرك الأساسي للسلوك». ولهذا، يشدد شحرور على «استحالة إحداث
إصلاحات يتم فيها استبعاد العامل الديني أو تحييده، كما حصل في الغرب، وأن
بالإمكان إقناع الناس بأن حاجتهم إلى برلمانات وتعددية حزبية وصحافة أكبر من
حاجتهم إلى مجالس للإفتاء». إذاً، لا فارق جوهرياً بين المشاريع الإسلامية «المعتدلة»
أو المتطرفة، فالفكرة المحورية واحدة. وإنّ غياب المصطلحات «السلفية» (مثل «حاكمية
الله» أو «الإسلام هو الحل») لا يعني عدم وجودها الفعليّ، بل هي موجودة ضمن قالب
آخر يبدو أكثر «حداثة» و«معاصرة».
الإسلام
هو الحل، ولكن ليس ذلك الإسلام التراثي التقليدي. هذه هي الفكرة الفعليّة لمشروع
محمد شحرور، برغم تخفّيها ضمن أقنعة متعددة، بصرف النظر عن مدى جرأة الطروحات
المتعلقة بتفاصيل فقهيّة محددة. إذ ما معنى التركيز الدائم على إدراج العام 1923،
بوصفه «عام سقوط الخلافة»، إن لم يكن القصد من ذك الإشارة إلى مشروع دينيّ لبناء
دولة أخفق أو ضل طريقه أو أخطأ في الوسائل؟ وما معنى التشديد على تفسير أوحد لقضية
اختلاف الإصلاح الديني بين الغرب والشرق، إن لم يكن القصد هو الوصول إلى النتيجة
القائلة إنّ مجتمعاتنا لا تحتاج فصل الدين عن الدولة (وهي نتيجة يتشارك فيها شحرور
مع محمد عابد الجابري وحسن حنفي، وإن اختلفت الصياغة). وأخيراً، ما معنى الإشارة
إلى وجود «حدود عليا» و«حدود دنيا» في تفسير القضية الإشكالية للحدود الإسلامية في
مسائل قطع اليد والربا، إن لم يكن القصد هو التأكيد على «سماحة» الدين الذي يسمح
بتفسيرات متعددة تختلف باختلاف الأزمنة؟ ولا بد من الإشارة، أخيراً، إلى أنّ
القضية الأخيرة بالذات بدت بمثابة ارتداد لمحمد شحرور عن أفكاره القديمة، إذ كان
في كتبه السابقة أشد صرامة في التأكيد على أن التفسير الحالي لمسائل الحدود
الإسلامية خاطئ بالمطلق، بينما أعاد صياغة أفكاره في هذا الكتاب، بحيث سمح بإدراج
هذه التفسيرات بوصفها اجتهادات فقهية يمكننا انتقاء الأنسب بينها.
نُشرت في جريدة «الأخبار» 1/8/2014