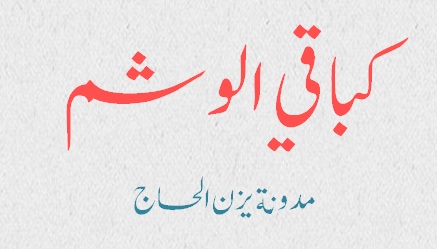لطالما كانت
مسألة فلسطينيي الداخل (أو فلسطينيي الـ 48) مثار جدال كبير في الأوساط الأكاديمية
في إسرائيل وخارجها. ويمكن القول إنّ الاهتمام الأكبر بهذه الشريحة السكانية، التي
اختلفت تسمياتها (بحسب وجهة النظر التي يتبناها هذا الكاتب أو ذاك) بدأ إثر
الانتفاضة الأولى عام 1987. ابتداء من هذا العام فرض فلسطينيو الداخل أنفسهم بقوة
في المشهدين الفكري والسياسي في آن، كجماعة قومية شكّلت، ولا تزال، عقبة كبيرة
أمام تكريس مفهوم «الدولة اليهودية» الذي اشتدّ الجدال حوله منذ التسعينيات.
يتناول إيلان
بابه (1954) في كتابه «الفلسطينيون المنسيّون: تاريخ فلسطينيي 1948» (2011)، الذي
صدرت نسخته العربية بترجمة هالة سنّو عن «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» (2013)،
تاريخ هذه الجماعة منذ نكبة عام 1948 وصولاً إلى نهاية القرن العشرين. يستهل بابه
كتابه بإهداء لإحياء ذكرى الشهداء الفلسطينيين الثلاث عشر الذين قتلتهم الشرطة
الإسرائيلية مع اندلاع الانتفاضة الثانية في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2000.
وبهذا، يفرض بابه وجهة نظره – لمن لا يعرفه – بشكل واضح؛ سيكون الكتاب أقرب
إلى الرؤية الفلسطينية في تدوين الأحداث. تلك الرؤية التي تبناها (بدرجات متفاوتة)
أعضاء تيار «المؤرخين الجدد»، عدا عن مفكّرين آخرين، في إعادة كتابة تاريخ القضية
الفلسطينية ابتداء بالنكبة. ويمكن القول، عموماً، بأن بابه يبدو في منتصف المسافة
في التناول الموضوعي لتاريخ هذه المسألة بين بيني موريس الأقرب للرؤية الصهيونية
ونورمن فنكلستين الأكثر شراسة في تبنيه للرؤية الفلسطينية للمسألة، وإن كان
فنكلستين متخصصاً بشكل أكبر في المحرقة النازية.
يبرر بابه عدم
وجود محاولات سابقة لتدوين تاريخ فلسطينيي الداخل إلى «التاريخ قصير الأمد» الذي
يمتد إلى 65 عاماً فقط، وبشكل أكبر إلى افتقار هذه الجماعة إلى «معالم واضحة
لهويتها، سواء كانت عرقية أو ثقافية أو قومية أو جغرافية أو حتى سياسية».
وانطلاقاً من هذه النقطة، يشرح بابه تطورات وتباينات التسمية التي ستلتصق بهذه
الجماعة مع تعاقب السنين والحكومات والحروب. إذ بدأت مأساتهم عملياً مع النكبة حين
كانوا يُعرّفون داخل إسرائيل بكونهم «الأقلية العربية»، مع ملاحظة إدراج الدين لا
القومية تحت بند «الجنسية» في البطاقات الشخصية. وهنا، يختلف بابه عن زملائه من
المؤرخين الجدد، وبالطبع عن المؤرخين الصهيونيين التقليديين، حينما يؤكد بأن هذه
الآلية البيروقراطية كانت تترافق مع آليات قانونية وتشريعية تمييزية تعمل على
تجريد الفلسطينيين من كل ما يملكون «إما أن يخلّفوا وراءهم كل شيء، وإما أن تُسلب
منهم أملاكهم»في عملية منهجية كشفت عنها الوثائق القانونية لتلك المرحلة.
وبذلك بدأت
معركة فلسطينيي الداخل المتسمة بمراحل وتنويعات مختلفة؛ إذ كانت، ضد الإسرائيليين،
معركة ضد الإقصاء وبهدف تحقيق مواطنة كاملة، فيما كانت ضد النظرة الظالمة العربية
والفلسطينية خارج الأرض المحتلة المتلخصة في كونهم «خونة». وتلخص هذا الموقف عبارة
الكاتب رائد حسين في مؤتمر دول عدم الانحياز ببلغراد (1959): «من نكون نحن عرب
إسرائيل؟ هنا يعتبروننا طابوراً خامساً وهناك خونة. نعيش في عالمين ولا ننتمي إلى
أي منهما». وستكون هذه «الهوية الغامضة» هي الأساس الذي ستستند إليه هذه الجماعة
في معاركها القادمة. إذ يؤكد بابه بأنّ «غريزة البقاء هي التي سيّرت مجرى النشاط
السياسي» في ما بعد، وبالتوازي مع تلك الغريزة كان لا بد من إيجاد «حاضنة» للتعبير
عن صوت هذه الجماعة؛ وبالتأكيد، كان الخيار الأفضل هو الحزب الشيوعي الإسرائيلي،
فيما إذا استثنينا جماعات أصغر (الدروز والبدو) ممن فضّلوا الالتحاق بالخدمة العسكرية
في الجيش الإسرائيلي طمعاً بمكاسب أكبر، أو على الأقل باعتراف رسمي بكونهم مواطنين
كاملي الحقوق.
ابتداء من
الخمسينيات وصولاً إلى نهاية القرن، بدا وكأن الأحزاب هي المكان الأمثل للبحث عن
هوية محددة لفلسطينيي الداخل، ومن ثم العمل على بلورتها. ومع اندلاع الانتفاضة
الثانية، بدأت الهجرة المعاكسة من الأحزاب إلى الحياة العامة والمنظمات غير
الحكومية التي وصل عددها عام 2001 إلى 600 منظمة تقريباً، باتت هي الساحة الفعلية
لتأكيد وجود الفلسطينيين داخل البيئة الإسرائيلية العنصرية. ولا بد من الملاحظة
بأن إيقاع «نضال» فلسطينيي الداخل كان مترافقاً دوماً بوجود شخصية قيادية تضبطه.
إذ عمل كل من إميل توما وإميل حبيبي، بين عامي 1957-1958، على السعي إلى تأكيد
الهوية القومية داخل إسرائيل عبر اعتناق استراتيجية«عدم الانخراط في صراع مع
الدولة اليهودية»، ليثمر هذا العمل لاحقاً في «انتصار القومية على الأممية» بعد
انسحاب الأعضاء الفلسطينيين من الحزب الشيوعي القديم «ماكي» وإنشاء «اللائحة
الشيوعية الجديدة» (راكاح)، في خطوة استطاع فيها إميل حبيبي ورفاقه تثبيت هوية
قومية لهم. وبعد الانتصار المفاجئ لتوفيق زيّاد في الانتخابات البلدية في الناصرة
(1975)، تنبّه الفلسطينيون بشكل أكبر إلى هويتهم المفقودة، بخاصة بعد التصعيد
الإسرائيلي الشرس، وصولاً إلى «يوم الأرض» (30 آذار (مارس) 1976) الذي شكّل
البداية الفعلية للهوية القومية الفلسطينية. ثم جاء عام 1996 ليحمل مفاجأة كبرى هي
ظهور حزب وطني، ليس صهيونياً أو إسلامياً أو شيوعياً، هو «التجمع الوطني
الديمقراطي» («البلد») بقيادة عزمي بشارة الذي استطاع دخول الكنيست، ومن ثم الترشح
إلى رئاسة الوزراء عام 1999، قبل أن يتم نفيه عام 2007. ويشير بابه إلى أن السنوات
الأخيرة التي تلت نفي بشارة شهدت انقسامات في صفوف الفلسطينيين ليعود ذلك
الاستقطاب الحاد بين «علمانيين» و«إسلاميين» للظهور ميدانياً عدا عن المنظمات غير
الحكومية التي أصبحت هي الوسيلة الأبرز في الصراع القانوني والوجودي لإثبات أحقية
الفلسطينيين بمواطنة كاملة داخل إسرائيل.
وعلى عكس
الآراء السائدة في الأوساط الأكاديمية (كما عند سامي سموحة وإيلي ريخيس) التي تقول
بأن اتفاقية أوسلو «سرّعت عملية «أسرلة الفلسطينيين» في إسرائيل، وأبعدتهم عن
القضايا الفلسطينية الجامعة لصالح القضايا المحلية»، يؤكد بابه العكس، إذ إن أوسلو
زادت الشرخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا سيما في انتخابات عام 1999، حينما
قام عدد كبير منهم بالتصويت بأوراق بيضاء (بعد أن كانت نسبة المقترعين الفلسطينيين
تصل إلى 85%) لأنهم «شعروا بعدم قدرتهم على رؤية أي فرق بين اليمين واليسار في
المعسكر السياسي اليهودي»، بصرف النظر عن مواقفهم المتناقضة من ياسر عرفات والسياسات
الجديدة لمنظمة التحرير. كما يشير إلى أن تصاعد العنف الإسرائيلي بعد الانتفاضة
الثانية ساهم في ولادة جيل فلسطيني جديد شاب «يؤكد على حقوقه، ويلتزم التزاماً
شديداً التعريف الدقيق بالمجموعة التي انتمى إليها بصفته مجموعة قومية». أي أن
الصراع عاد إلى صيغته الوجودية القديمة، ولم يعد مقتصراً على معارك قانونية
وتشريعية صغيرة.
وبالرغم من
الانتقادات القاسية التي يوجهها بابه إلى إسرائيل التي يعتبرها «هجيناً بين دولة
استعمارية استيطانية ونظام استخباري مفروض على سكانه الفلسطينيين» (بل ووصل إلى حد
تسميتها بـ «دولة المخابرات الإسرائيلية»)، إلا أن ثمة مواضع في الكتاب يبدو فيها
تردد بابه في اتخاذ موقف حاسم. ففي الحديث عن مجزرة كفر قاسم، لا نجد رأياً واضحاً
بشأن ما جرى برغم الوثائق الموجودة، إذ يبدو ميالاً بشكل أكبر إلى اعتبار أن
الكولونيل يساكر شادمي (المسؤول العسكري عن العملية) «أعطى الأوامر على افتراض أنه
كان يباشر تنفيذ الخطة (س – 49) التي افتضحت أثناء المحاكمة»؛ أي إنّ بابه يرفع
المسؤولية، ولو جزئياً، عن القائد العسكري بدعوى أن الخطة صادرة عن الحكومة، حتى
لو كان ذلك بشكل سري. ثم يعود (في موضع آخر) ليرفع المسؤولية عن شلومو بن عامي
حينما كان وزيراً للشرطة في حكومة إيهود باراك في الانتفاضة الثانية (2000)، بدعوى
أن الشرطة «خالفت أوامره باستخدامها قناصة ووحدات هجومية مدربة على التعاطي مع
إرهابيين يهاجمون المدنيين، وليس مع مدنيين يتظاهرون احتجاجاً على سياسات إرهابية»،
مكتفياً بالاعتماد على أقوال ضباط في الحالة الأولى، وعلى حوار للوزير مع «هآرتس»
في الحالة الثانية.
بالطبع، يشكّل
كتاب «الفلسطينيون المنسيّون» إضافة مهمة إلى المكتبة الخاصة بالقضية الفلسطينية،
بخاصة وأن جماعة فلسطينيي الداخل شبه مجهولة في المكتبة العربية، باستثناء كتب
قليلة (متفاوتة القيمة) صدرت في الأعوام الأخيرة. ومع الخلو شبه الكامل للساحة
الأكاديمية الفلسطينية من المتخصصين في تدوين تاريخ فلسطينيي الداخل، وتاريخ نكبة
العام 1948 بشكل خاص، سنبقى في السنوات القادمة أسرى الرواية الإسرائيلية للأحداث،
فيما عدا استثناءات نادرة، وأسرى الصورة النمطية عن «الآخر» الفلسطيني خلف الجدار
العازل.
نُشرت في جريدة «الأخبار» 8/2/2014